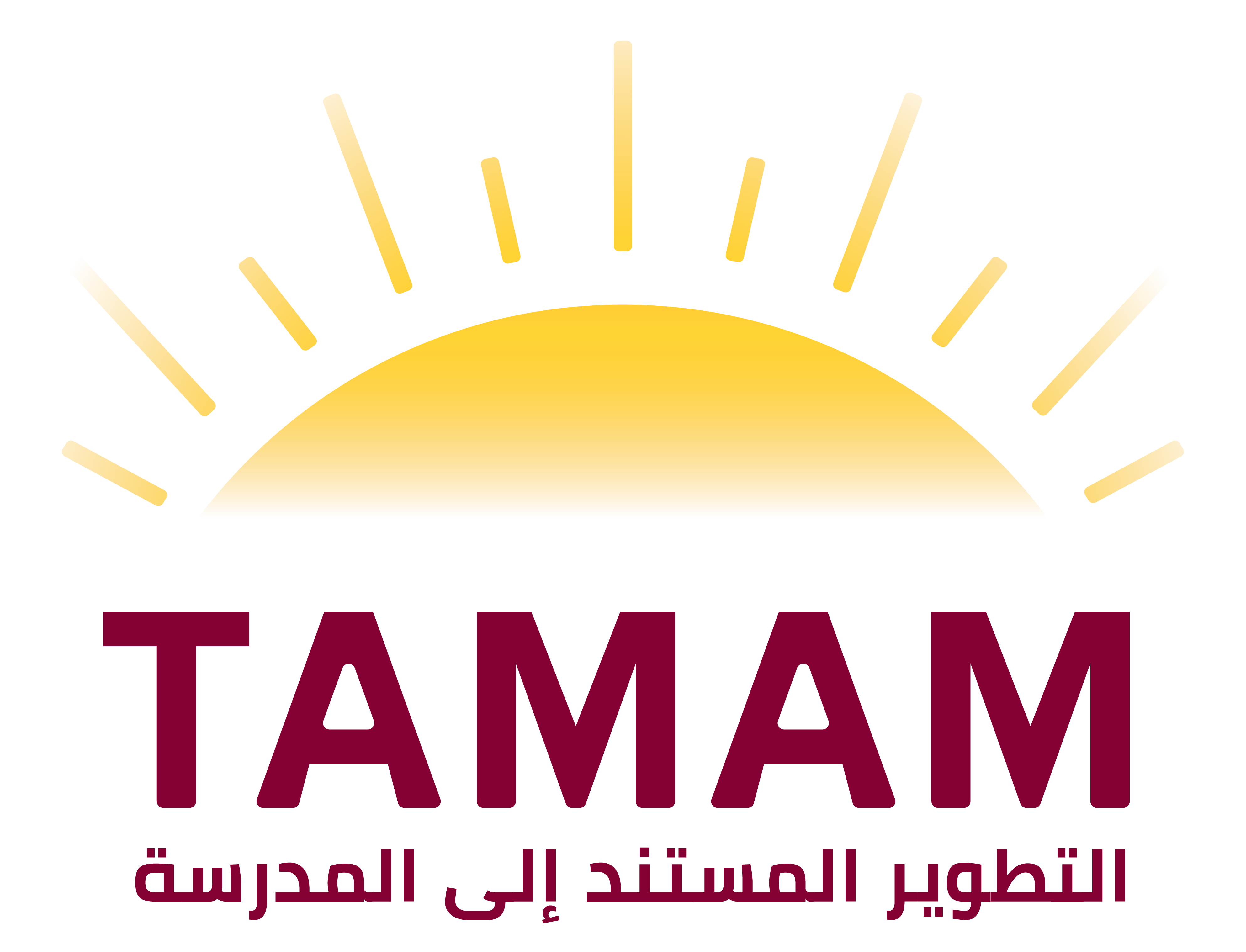استكشفت هذه الدراسة الدور الذي تلعبه الحوكمة في تمكين واستدامة التحسين القائم على المدرسة من خلال تجربة مشروع تمام مع ست مدارس حكومية دخلت في شراكة معه منذ عام 2015 والتي تشكل جزءًا من مركزه في لبنان. وقد هدفت الدراسة إلى معرفة عناصر الحوكمة التي أعاقت أو سهّلت الأداء التنظيمي للمدارس المختارة، لا سيّما تنفيذ مشاريع التحسين واستعداد الموظفين للابتكار. اعتمدت الدراسة منهجية نوعية وجمعت البيانات بشكل رئيسي من خلال تحليل الوثائق. وقد تنوعت هذه البيانات الموثقة وتنوعت ما بين نصوص من البيانات الخام، ومذكرات من المقابلات، وتقارير تقدم المشاريع، والتقارير الفنية. وقد انقسمت البيانات التي تم تحليلها إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تلك التي تم الوصول إليها في المقام الأول من خلال مجموعة فرعية من بنك بيانات مشروع تمام والثانية تلك التي أتيحت للجمهور على المواقع الإلكترونية الحكومية في شكل مراسيم تشريعية. بعد ذلك، قمت بتحليل البيانات باستخدام عملية استنتاجية بشكل أساسي باستخدام رموز محددة مسبقًا تم تطويرها من إطار مفاهيمي قمت بتجميعه من الدروس المستفادة من الدراسات التجريبية لباحثين بارزين حول كيفية استدامة تحسين المدارس من خلال الحوكمة، وكذلك الدراسات التي استكشفت التطبيقات العملية لنموذج الحوكمة اللامركزية المعروف باسم نموذج الإدارة المدرسية. ثم قمت بعد ذلك بفرز هذه البيانات إلى هذه الرموز التي تم إنشاؤها وإجراء مقارنة بين الاثنين لتكوين فهم متعمق للظاهرة المدروسة. وكخطوة أخيرة، تركت مجالًا لشكل من أشكال التحليل الاستقرائي لظهور موضوعات بديلة. توصلت الدراسة إلى ثلاثة مكونات للحوكمة سهّلت تنفيذ المدارس لمشاريعها التحسينية في سياق الدراسة. وهي الثقة الراسخة وقنوات التواصل الإيجابية غير الرسمية مع المشرفين الحكوميين؛ والإرشاد غير الرسمي الذي تلقاه مديرو المدارس من المسؤولين المطلعين على هيكل الحوكمة وعمل النظام؛ والدعم المالي البلدي. أما بالنسبة لمكونات الحوكمة التي وجد أنها تعيق التنفيذ، فقد وجدت الدراسة سبعة منها. تمثلت العناصر الثلاثة الأولى في غياب التواصل الرسمي ثنائي الاتجاه والمتسق مع المشرفين الحكوميين؛ وغياب التنسيق البلدي في دعم مبادرات تحسين المدارس؛ وعدم وجود تواصل واضح ومعلومات كافية من قبل الوزارة حول السياسات والمبادرات التعليمية المكلفة. أما الأسباب الأربعة المتبقية فهي إثقال كاهل المدارس بمشاريع من أعلى إلى أسفل لا تتماشى مع مبادراتها الخاصة، ومركزية عملية صنع القرار في الوزارة، وسوء الإدارة في توزيع المهام على الموارد البشرية في المدارس، وغياب فرص تدريب المعلمين المنتظمة التي تستجيب لاحتياجات المعلمين. أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال البحثي للدراسة الذي يستكشف تأثير الحوكمة على استعداد الفريق القيادي في المدرسة للابتكار، لم تجد الدراسة سوى مكونات الحوكمة المعرقلة. وتمثلت هذه المكونات في وجود مناهج دراسية قديمة ومقيدة ومفروضة؛ وغياب الموجهين الذي يحد من قدرة المعلمين على توليد أفكار مبتكرة؛ والتطوير المهني المقرر الذي لا يلبي التطلعات الشخصية للمعلمين؛ ونقص الموارد المستدامة لمشاركة المعلمين في الابتكار؛ وعدم التركيز على التأهيل المهني في توظيف المعلمين. أخيرًا، ناقشت الدراسة النتائج من خلال عدسة مقارنة مع الإطار المفاهيمي المقترح والأدبيات للمساعدة في الخروج بتوصيات مستنيرة للبحوث والممارسات المستقبلية. كانت إحدى التوصيات للبحوث المستقبلية هي إجراء دراسة مقارنة بين المدارس التي تشارك مع تمام والمدارس الحكومية التي لم يشارك ممارسوها إلا في مبادرات التحسين من أعلى إلى أسفل بتكليف من الوزارة أو المدارس التي لم يكتسب ممارسوها الكفاءات اللازمة لقيادة وتفعيل التحسين القائم على المدرسة. أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بالممارسة، فقد كانت إحدى التوصيات الرئيسية للدراسة هي تفويض المزيد من سلطة اتخاذ القرار لموظفي مكتب التعليم الإقليمي بحيث تصبح القرارات التعليمية مستنيرة باحتياجات المدارس ومستجيبة وفي الوقت المناسب للطلبات المقدمة من المدارس.
دور الحوكمة في تمكين واستدامة تحسين المدارس: حالة مدارس تمام في لبنان – قمر فتال (2024)
انطلاقة تمام
بدأ تمام عندما النائب الأول لرئيس مدرسة الظهران الأهلية في المملكة العربية السعودية, د. سالي التركي , مع أستاذين في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB), د. سوما بوجعودة والدكتور مراد جرداق , لاقتراح مبادرة إصلاحية مدرسية مبادرة إصلاح مدرسية التي يمكن أن توليد نظريات قابلة للتنفيذ ترتكز على السياق الاجتماعي والثقافي للمنطقة العربية.
(1) عدم وجود أساس ثقافي, البحث–مجموعة من المعارف التربوية المستندة إلى البحوث والقائمة على أفضل الممارسات الدولية والقادرة في الوقت نفسه على معالجة التحديات التي تواجه الممارسين التربويين العرب، (2) الافتقار إلى القدرة والاستعداد بين الممارسين في المدارس لقيادة عملية تحسين مبتكرة للمدارس، (3) ضعف جودة برامج التطوير المهني المقدمة للممارسين التربويين العرب، (4) غياب المساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة بالأدلة على جميع مستويات النظام التعليمي.
د. التركي, د. بو جودة و قام الدكتور جرداق بصياغة التصميم الأولي في عام 2007, وحصلوا على أول منحة من المؤسسة العربية Tالفكر العربي Fمع التركيز على إدخال البحث الإجرائي كأداة للتنمية على جميع المستويات.
د. ريما كرامي, انضمت الأستاذة المشاركة في الجامعة الأميركية في بيروت إلى تمام كباحثة بعد شهرين من إطلاق المشروع وسرعان ما أصبحت واحدة من باحثيه الرئيسيين الثلاثة وعضوًا في فريقه التوجيهي. في تلك المرحلة المبكرة، لم يكن التصميم الأولي للمشروع يتضمن أهدافاً واستراتيجيات مطورة بالكامل للتنفيذ. وبالتالي، تمثّل جزء كبير من دور د. كرامي في المرحلة الأولى من تمام في وضع تصور للصلة بين البحث الإجرائي والتحسين القائم على المدرسة وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف تمام. وقد أدى ذلك إلى تصميم أنشطة التطوير المهني (PD) لـ بناء القدرات القيادية للشروع في تحسين المدرسة وقيادتها. في عام 2012، أكمل الدكتور كرامي التصميم الأول لبرنامج بناء القدرات(الموثق في التقرير الفني الرابع) الذي أصبح المخطط الذي حدد برنامج بناء القدرات وأطر الدراسات البحثية لتمام. كما كان نموذج التطوير المهني هذا بمثابة الأساس للحصول على ثلاث منح إضافية من مؤسسة الفكر العربي, بلغ مجموعها ما يقرب من 2,000,000 دولار و ما جعل “تمام” الأطول على الإطلاق–مشروع بحثي تعليمي ممول بشكل مستمر في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت.
بدءاً من عام 2015، انتقل الدكتور كرامي إلى دور القيادة الكاملة لأنشطة البحث والتطوير في تمام بصفته مديراً إبداعياً للمشروع، بينما واصل اثنان من المبادرين في تمام (الدكتور التركي والدكتور بو جودة) مساهمتهما في المشروع بدور استشاري. منذ عام 2015 تمام يقود الفريق التوجيهي الذي يقوده د. كرامي ويتألف من فريق من الباحثين والمصممين والاستشاريين أنشطة البحث والتطوير في تمام.
بداية مشروع تمام
(AUB)بدأ مشروع تمام عندما قامت الدكتورة سالي التركي، نائب الرئيس الأعلى لمدارس الظهران الأهلية في المملكة العربية السعودية، بالتواصل مع أستاذين في الجامعة الأمريكية في بيروت ، وهما الدكتور صوما ابوجودة والدكتور مراد جرداق، لاقتراح مبادرة إصلاح مدرسية تهدف إلى إنتاج نظريات قابلة للتطبيق مستمدة من السياق الاجتماعي والثقافي في المنطقة العربية.
.جاءت هذه المبادرة استجابة لعدة تحديات رئيسية
غياب قاعدة معرفية تعليمية تستند إلى البحث العلمي ومرتبطة بالثقافة العربية، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقادرة على معالجة التحديات التي يواجهها الممارسون التربويون العرب
.ضعف الشعور بالمسؤولية والاستعداد لدى الممارسين في المدارس لقيادة عمليات تطوير مدرسي مبتكرة
.تراجع جودة برامج التطوير المهني المقدمة للممارسين التربويين العرب
.غياب المساءلة وصنع القرار المبني على الأدلة في جميع مستويات النظام التعليمي
في عام 2007، قامت الدكتورة التركي والدكتور ابوجودة والدكتور جرداق بوضع التصميم الأولي لمشروع تمام، وحصلوا على أول منحة من مؤسسة الفكر العربي، مع التركيز على إدخال البحث الإجرائي كأداة للتطوير على جميع المستويات.
انضمت الدكتورة ريما كرمي، الأستاذة المشاركة في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى مشروع تمام كباحثة بعد شهرين من إطلاق المشروع، وسرعان ما أصبحت واحدة من الباحثين الرئيسيين الثلاثة وعضواً في الفريق التوجيهي للمشروع. في هذه المرحلة المبكرة، لم يتضمن التصميم الأولي أهدافاً واستراتيجيات واضحة للتنفيذ، مما جعل دور الدكتورة كرمي في المرحلة الأولى يتمحور حول وضع تصور للربط بين البحث الإجرائي والتطوير المدرسي، وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف تمام. ونتج عن ذلك تصميم أنشطة التطوير المهني لبناء قدرات القيادة التربوية لبدء ودفع عملية التحسين المدرسي.
في عام 2012، أكملت الدكتورة كرمي أول تصميم لبرنامج بناء القدرات (الموثق في التقرير الفني الرابع)، والذي أصبح بمثابة الإطار المرجعي الذي يحدد برنامج بناء القدرات ويؤطر الدراسات البحثية لمشروع تمام. كما ساهم هذا النموذج في الحصول على ثلاث منح إضافية من مؤسسة الفكر العربي، بلغ مجموعها حوالي 2,000,000 دولار، مما جعل تمام أطول مشروع بحثي تربوي مستمر التمويل في تاريخ الجامعة الأمريكية في بيروت.
ابتداءً من عام 2015، انتقلت الدكتورة كرمي إلى دور القيادة الكاملة لأنشطة البحث والتطوير في تمام كمديرة إبداعية، بينما واصل اثنان من مؤسسي المشروع (الدكتورة التركي والدكتور بوجاودة) تقديم مساهماتهما في المشروع بصفة استشارية. منذ ذلك الحين، قاد الفريق التوجيهي لتمام، برئاسة الدكتورة كرمي وبدعم من فريق مكون من باحثين ومصممين ومستشارين، أنشطة البحث والتطوير للمشروع.
المدرسة المجتمعية المتجددة ذاتياً
تطمح تمام إلى تحويل المدرسة إلى مؤسّسة متجدّدة ذاتياّ تمتلك خزينًا من القدرات القياديّة للتغيير، حيث يتعاون الممارسون التربويون فيها وينخرطون في مجتمعات التعلم المهنية لقيادة التطوير الذي يرمي إلى بناء جيل قياديّ فاعل في مجتمعه. توفر هذه المؤسسات المتجددة المرونة والمساحة المهنية التي تُهيئ فرصًا لتبادل الخبرات والعمل التشاركي في تحقيق التطوير وتحسين تعلم الطلاب. ونتيجة لذلك، يتم تحفيز الممارسين على إطلاق وقيادة مبادرات تطوريّة بشكل تشاركي. كما تشكل هذه الجهود التعاونية منصّة للتعلم المستمر والنمو، مما يتيح للمشاركين استخلاص الدروس من العثرات والتجارب السابقة. تتبنّى هذه المؤسسات المتجددة مسؤولية تعزيز التحول الثقافي والاجتماعي بنشاط، وتركّز بشكل خاص على إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين مسؤولين ومساهمين نشطين. ولتحقيق رؤية المدارس باعتبارها عنصراً أساسيّاً في التحول الاجتماعي، من الضروري تعزيز القدرات القيادية على جميع المستويات، مع التركيز على تمكين المعلمين تحديداً. من خلال التوجيه المستمر والشغوف، يصبح المعلمون قدوة يحتذى بها، مما يمكّن الطلاب من التطوّر إلى قادة يساهمون بفعاليّة في تقدّم مجتمعاتهم.
التربوي
تكرّس “تمام” جهودها لتمكين التربويين من خلال ترسيخ عادات ذهنية تحوليّة تجعلهم متعلمين نشطين، وقادة للتغيير، ومنتجين للمعرفة. من خلال هذا التمكين، ينمّون قدراتهم ليصبحوا قادة يفكرون بعمق ويستقصون، ويتحمّلون المسؤولية المشتركة عن نجاح مؤسستهم التعليمية وتحقيق إنجازات طلابهم. كقادة لتطوير مؤسساتهم، يكتسب الممارسون التربويّون في تمام مجموعة غنيّة من الكفايات والمهارات التي تزيد من دافعيتهم والتزامهم بتحسين مؤسساتهم. هذا الدافع يشجّعهم على بدء وقيادة عمليات التطوير المستدام في المدارس. ونتيجة لذلك، يتعاونون في بناء فهم شامل للمشكلات التي يواجهونها، ويقترحون حلولًا عملية ومُقنعة لتلك المشكلات، ويُوصون بتغييرات في العمليات والممارسات القائمة في مؤسساتهم التعليمية. أثناء مشاركتهم في دورات من البحث والتجريب وحل المشكلات المتكررة، يبقى الممارسون نقديين تجاه افتراضاتهم الراسخة ومنفتحين لتغيير النموذج المهني الذي يوجّه أساليبهم. هذا الالتزام بالممارسة التفكريّة والبحث والاستكشاف في أثناء العمل يُسهم في إحداث تغييرات تحويلية ومستدامة في المؤسسات التربوية، يقودها الممارسون التربويون في الميدان، ويساهم في انتاج نظريات عمليّة تتناسب مع السياق الاجتماعي والثقافي لتلك المؤسسات.
تعلّم الطالب هو أساس عمل تمام. يسعى تمام إلى بناء خزين قيادي وبيئة مدرسيّة حاضنة تزيل العقبات التي تقف في وجه تمكين المتعلّم من بناء قدراته ونموّه الشخصّي. تتبنّى مقاربة تمام “قيادة المتعلّم” لدعم وتعزيز المتعلمين كمساهمين رئيسيّين في العمليّة التعليميّة وفي التنمية المجتمعيّة. من هنا، تتناول رؤية تمام سمات الطالب التمامي التي تضمّ مجموعة من القيم والمهارات والقدرات القياديّة التي نأمل الوصول إليها في الطالب المتخرّج من مدراس تمام المشاركة.
تمّ العمل على سمات الطالب التمامي بطريقة جماعيّة تعاون فيها شركاء مشروع تمام من المدارس والمؤسسات التربوية في سلسلة من النقاشات والاجتماعات على وضع سمات الطالب التمامي.
تمّ ادراج سمات الطالب التمامي تحت الفئات\المجالات الثلاث التالية:
– مواطن مسؤول
– انسان ذو أخلاق
– متعلّم دائم