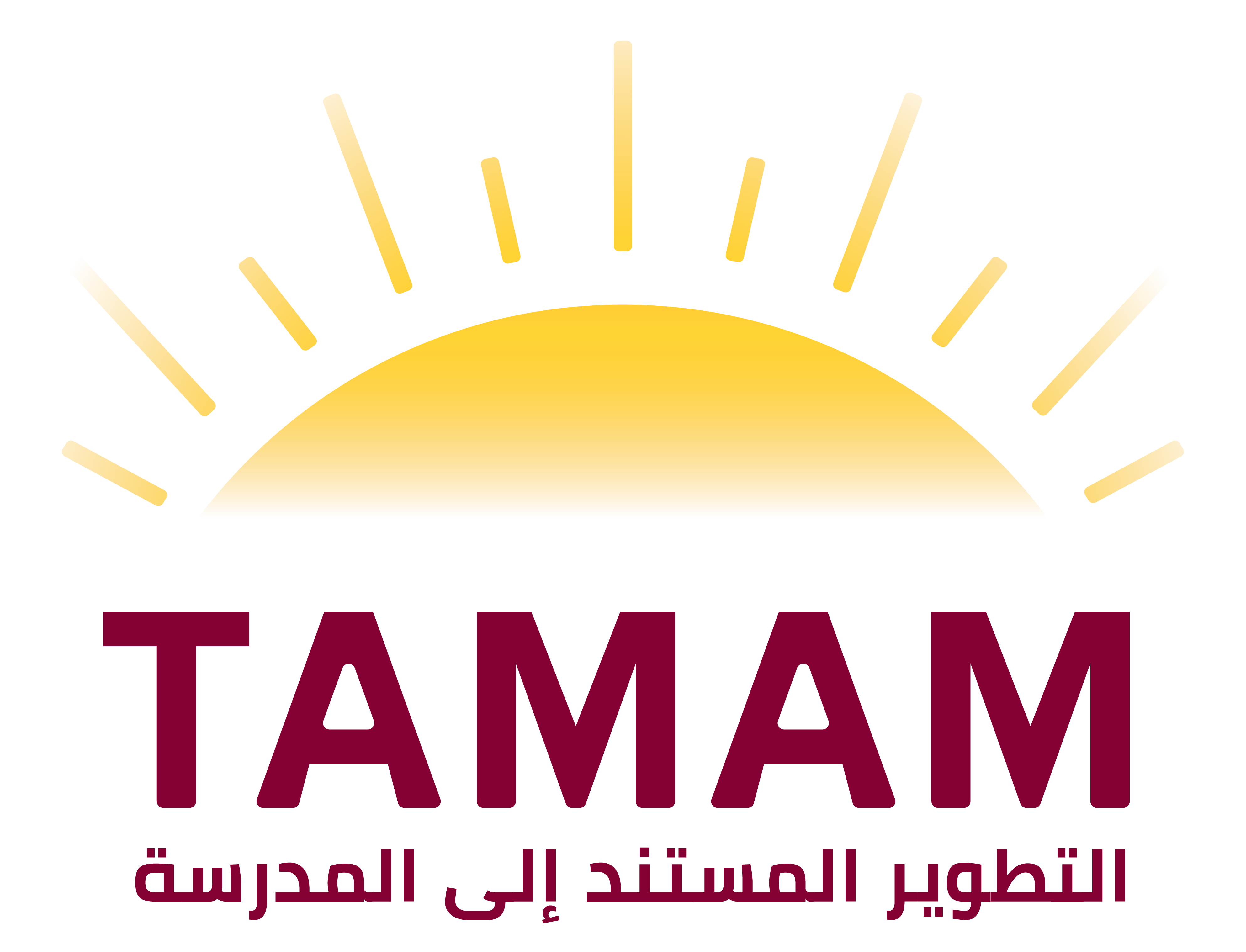لا تزال القيادة والريادة مرتبطة بالمرأة في القطاع التعليمي في العالم العربي. فقد كشف تقرير حديث عن النساء في القطاع التعليمي في المنطقة العربية (كرم وآخرون، 2021) أن نسبة احتفاظهن وترقيتهن منخفضة للغاية، مما يساهم في قلة عدد النساء في المناصب القيادية. منذ منتصف السبعينيات، درس عدد متزايد من الدراسات الدولية تجارب النساء في المناصب القيادية التعليمية الرسمية (شكشافت، 1999) بينما أهملت دراسة القيادات غير الوظيفية. وتعد هذه فجوة مثيرة للدهشة خاصة مع التحول الحالي نحو وضع تصور للقيادة على أنها ممارسة التأثير (سبيلين، 2006؛ يوكل، 2010). ويتجلى النقص في الدراسات التي تبحث في القيادات النسائية غير الموضعية بشكل أكبر في العالم العربي حيث لا يتم الاهتمام بتجارب القيادات التربوية النسائية حيث نادرًا ما يتم فحصها (عرار، 2018). واستجابةً للحاجة إلى دراسة تجارب القيادات النسائية العربية غير المنصبية، أجرينا دراسة مع مجموعة من 10 باحثات/مستشارات يقُدنَ في إطار شراكة بين الجامعة والمدرسة مشروعًا لتطوير المدارس في العالم العربي. ركّزت هذه الدراسة، من خلال منهجية دراسة الحالة النوعية النقدية، على فحص مفهومهنّ للقيادة الناجحة كنساء، والظروف التمكينية التي أدت إلى نجاحهنّ كقياديات واستراتيجياتهنّ التي استخدمنها للتغلب على التحديات التي واجهنها بسبب جنسهنّ. إن تطوير مثل هذا الفهم لتجارب القياديات التربويات من غير النساء هو أمر أساسي لأنه يساهم في تسليط الضوء على ما ينبغي توفيره لتمكين المعلمات، ومعظمهن من النساء، من القيادة من حيث هنّ، وهو أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق تحسين فعال للمدرسة (لامبرت، 2003).
تأملات في تطوير إطار عمل نسوي عربي الدروس المستفادة من استقصاء نقدي مع القيادات التربوية النسائية – ريما كرامي-عكاري وستيفاني جريديني (2022) – قدمت في مؤتمر جمعية التربية المقارنة والدولية (CIES)
انطلاقة تمام
بدأ تمام عندما النائب الأول لرئيس مدرسة الظهران الأهلية في المملكة العربية السعودية, د. سالي التركي , مع أستاذين في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB), د. سوما بوجعودة والدكتور مراد جرداق , لاقتراح مبادرة إصلاحية مدرسية مبادرة إصلاح مدرسية التي يمكن أن توليد نظريات قابلة للتنفيذ ترتكز على السياق الاجتماعي والثقافي للمنطقة العربية.
(1) عدم وجود أساس ثقافي, البحث–مجموعة من المعارف التربوية المستندة إلى البحوث والقائمة على أفضل الممارسات الدولية والقادرة في الوقت نفسه على معالجة التحديات التي تواجه الممارسين التربويين العرب، (2) الافتقار إلى القدرة والاستعداد بين الممارسين في المدارس لقيادة عملية تحسين مبتكرة للمدارس، (3) ضعف جودة برامج التطوير المهني المقدمة للممارسين التربويين العرب، (4) غياب المساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة بالأدلة على جميع مستويات النظام التعليمي.
د. التركي, د. بو جودة و قام الدكتور جرداق بصياغة التصميم الأولي في عام 2007, وحصلوا على أول منحة من المؤسسة العربية Tالفكر العربي Fمع التركيز على إدخال البحث الإجرائي كأداة للتنمية على جميع المستويات.
د. ريما كرامي, انضمت الأستاذة المشاركة في الجامعة الأميركية في بيروت إلى تمام كباحثة بعد شهرين من إطلاق المشروع وسرعان ما أصبحت واحدة من باحثيه الرئيسيين الثلاثة وعضوًا في فريقه التوجيهي. في تلك المرحلة المبكرة، لم يكن التصميم الأولي للمشروع يتضمن أهدافاً واستراتيجيات مطورة بالكامل للتنفيذ. وبالتالي، تمثّل جزء كبير من دور د. كرامي في المرحلة الأولى من تمام في وضع تصور للصلة بين البحث الإجرائي والتحسين القائم على المدرسة وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف تمام. وقد أدى ذلك إلى تصميم أنشطة التطوير المهني (PD) لـ بناء القدرات القيادية للشروع في تحسين المدرسة وقيادتها. في عام 2012، أكمل الدكتور كرامي التصميم الأول لبرنامج بناء القدرات(الموثق في التقرير الفني الرابع) الذي أصبح المخطط الذي حدد برنامج بناء القدرات وأطر الدراسات البحثية لتمام. كما كان نموذج التطوير المهني هذا بمثابة الأساس للحصول على ثلاث منح إضافية من مؤسسة الفكر العربي, بلغ مجموعها ما يقرب من 2,000,000 دولار و ما جعل “تمام” الأطول على الإطلاق–مشروع بحثي تعليمي ممول بشكل مستمر في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت.
بدءاً من عام 2015، انتقل الدكتور كرامي إلى دور القيادة الكاملة لأنشطة البحث والتطوير في تمام بصفته مديراً إبداعياً للمشروع، بينما واصل اثنان من المبادرين في تمام (الدكتور التركي والدكتور بو جودة) مساهمتهما في المشروع بدور استشاري. منذ عام 2015 تمام يقود الفريق التوجيهي الذي يقوده د. كرامي ويتألف من فريق من الباحثين والمصممين والاستشاريين أنشطة البحث والتطوير في تمام.
بداية مشروع تمام
(AUB)بدأ مشروع تمام عندما قامت الدكتورة سالي التركي، نائب الرئيس الأعلى لمدارس الظهران الأهلية في المملكة العربية السعودية، بالتواصل مع أستاذين في الجامعة الأمريكية في بيروت ، وهما الدكتور صوما ابوجودة والدكتور مراد جرداق، لاقتراح مبادرة إصلاح مدرسية تهدف إلى إنتاج نظريات قابلة للتطبيق مستمدة من السياق الاجتماعي والثقافي في المنطقة العربية.
.جاءت هذه المبادرة استجابة لعدة تحديات رئيسية
غياب قاعدة معرفية تعليمية تستند إلى البحث العلمي ومرتبطة بالثقافة العربية، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقادرة على معالجة التحديات التي يواجهها الممارسون التربويون العرب
.ضعف الشعور بالمسؤولية والاستعداد لدى الممارسين في المدارس لقيادة عمليات تطوير مدرسي مبتكرة
.تراجع جودة برامج التطوير المهني المقدمة للممارسين التربويين العرب
.غياب المساءلة وصنع القرار المبني على الأدلة في جميع مستويات النظام التعليمي
في عام 2007، قامت الدكتورة التركي والدكتور ابوجودة والدكتور جرداق بوضع التصميم الأولي لمشروع تمام، وحصلوا على أول منحة من مؤسسة الفكر العربي، مع التركيز على إدخال البحث الإجرائي كأداة للتطوير على جميع المستويات.
انضمت الدكتورة ريما كرمي، الأستاذة المشاركة في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى مشروع تمام كباحثة بعد شهرين من إطلاق المشروع، وسرعان ما أصبحت واحدة من الباحثين الرئيسيين الثلاثة وعضواً في الفريق التوجيهي للمشروع. في هذه المرحلة المبكرة، لم يتضمن التصميم الأولي أهدافاً واستراتيجيات واضحة للتنفيذ، مما جعل دور الدكتورة كرمي في المرحلة الأولى يتمحور حول وضع تصور للربط بين البحث الإجرائي والتطوير المدرسي، وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف تمام. ونتج عن ذلك تصميم أنشطة التطوير المهني لبناء قدرات القيادة التربوية لبدء ودفع عملية التحسين المدرسي.
في عام 2012، أكملت الدكتورة كرمي أول تصميم لبرنامج بناء القدرات (الموثق في التقرير الفني الرابع)، والذي أصبح بمثابة الإطار المرجعي الذي يحدد برنامج بناء القدرات ويؤطر الدراسات البحثية لمشروع تمام. كما ساهم هذا النموذج في الحصول على ثلاث منح إضافية من مؤسسة الفكر العربي، بلغ مجموعها حوالي 2,000,000 دولار، مما جعل تمام أطول مشروع بحثي تربوي مستمر التمويل في تاريخ الجامعة الأمريكية في بيروت.
ابتداءً من عام 2015، انتقلت الدكتورة كرمي إلى دور القيادة الكاملة لأنشطة البحث والتطوير في تمام كمديرة إبداعية، بينما واصل اثنان من مؤسسي المشروع (الدكتورة التركي والدكتور بوجاودة) تقديم مساهماتهما في المشروع بصفة استشارية. منذ ذلك الحين، قاد الفريق التوجيهي لتمام، برئاسة الدكتورة كرمي وبدعم من فريق مكون من باحثين ومصممين ومستشارين، أنشطة البحث والتطوير للمشروع.
المدرسة المجتمعية المتجددة ذاتياً
تطمح تمام إلى تحويل المدرسة إلى مؤسّسة متجدّدة ذاتياّ تمتلك خزينًا من القدرات القياديّة للتغيير، حيث يتعاون الممارسون التربويون فيها وينخرطون في مجتمعات التعلم المهنية لقيادة التطوير الذي يرمي إلى بناء جيل قياديّ فاعل في مجتمعه. توفر هذه المؤسسات المتجددة المرونة والمساحة المهنية التي تُهيئ فرصًا لتبادل الخبرات والعمل التشاركي في تحقيق التطوير وتحسين تعلم الطلاب. ونتيجة لذلك، يتم تحفيز الممارسين على إطلاق وقيادة مبادرات تطوريّة بشكل تشاركي. كما تشكل هذه الجهود التعاونية منصّة للتعلم المستمر والنمو، مما يتيح للمشاركين استخلاص الدروس من العثرات والتجارب السابقة. تتبنّى هذه المؤسسات المتجددة مسؤولية تعزيز التحول الثقافي والاجتماعي بنشاط، وتركّز بشكل خاص على إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين مسؤولين ومساهمين نشطين. ولتحقيق رؤية المدارس باعتبارها عنصراً أساسيّاً في التحول الاجتماعي، من الضروري تعزيز القدرات القيادية على جميع المستويات، مع التركيز على تمكين المعلمين تحديداً. من خلال التوجيه المستمر والشغوف، يصبح المعلمون قدوة يحتذى بها، مما يمكّن الطلاب من التطوّر إلى قادة يساهمون بفعاليّة في تقدّم مجتمعاتهم.
التربوي
تكرّس “تمام” جهودها لتمكين التربويين من خلال ترسيخ عادات ذهنية تحوليّة تجعلهم متعلمين نشطين، وقادة للتغيير، ومنتجين للمعرفة. من خلال هذا التمكين، ينمّون قدراتهم ليصبحوا قادة يفكرون بعمق ويستقصون، ويتحمّلون المسؤولية المشتركة عن نجاح مؤسستهم التعليمية وتحقيق إنجازات طلابهم. كقادة لتطوير مؤسساتهم، يكتسب الممارسون التربويّون في تمام مجموعة غنيّة من الكفايات والمهارات التي تزيد من دافعيتهم والتزامهم بتحسين مؤسساتهم. هذا الدافع يشجّعهم على بدء وقيادة عمليات التطوير المستدام في المدارس. ونتيجة لذلك، يتعاونون في بناء فهم شامل للمشكلات التي يواجهونها، ويقترحون حلولًا عملية ومُقنعة لتلك المشكلات، ويُوصون بتغييرات في العمليات والممارسات القائمة في مؤسساتهم التعليمية. أثناء مشاركتهم في دورات من البحث والتجريب وحل المشكلات المتكررة، يبقى الممارسون نقديين تجاه افتراضاتهم الراسخة ومنفتحين لتغيير النموذج المهني الذي يوجّه أساليبهم. هذا الالتزام بالممارسة التفكريّة والبحث والاستكشاف في أثناء العمل يُسهم في إحداث تغييرات تحويلية ومستدامة في المؤسسات التربوية، يقودها الممارسون التربويون في الميدان، ويساهم في انتاج نظريات عمليّة تتناسب مع السياق الاجتماعي والثقافي لتلك المؤسسات.
تعلّم الطالب هو أساس عمل تمام. يسعى تمام إلى بناء خزين قيادي وبيئة مدرسيّة حاضنة تزيل العقبات التي تقف في وجه تمكين المتعلّم من بناء قدراته ونموّه الشخصّي. تتبنّى مقاربة تمام “قيادة المتعلّم” لدعم وتعزيز المتعلمين كمساهمين رئيسيّين في العمليّة التعليميّة وفي التنمية المجتمعيّة. من هنا، تتناول رؤية تمام سمات الطالب التمامي التي تضمّ مجموعة من القيم والمهارات والقدرات القياديّة التي نأمل الوصول إليها في الطالب المتخرّج من مدراس تمام المشاركة.
تمّ العمل على سمات الطالب التمامي بطريقة جماعيّة تعاون فيها شركاء مشروع تمام من المدارس والمؤسسات التربوية في سلسلة من النقاشات والاجتماعات على وضع سمات الطالب التمامي.
تمّ ادراج سمات الطالب التمامي تحت الفئات\المجالات الثلاث التالية:
– مواطن مسؤول
– انسان ذو أخلاق
– متعلّم دائم